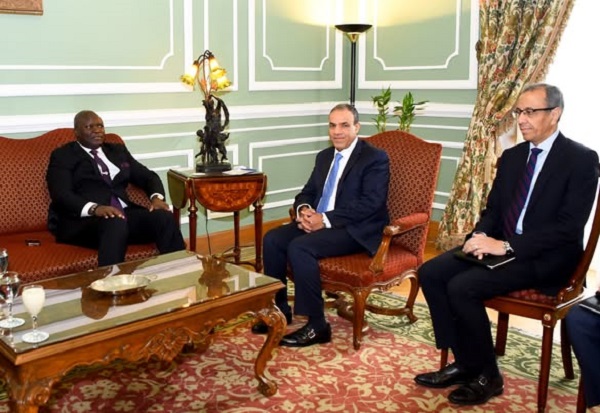قلما نجد فيلسوفاً قادراً على طرح أفكاره بلغة بسيطة وسهلة قادرة على الوصول إلى الجمهور العام والمثقفين، فما بالنا إذا تجلت هذه القدرة في تناول موضوع على قدر كبير من التعقيد والحساسية، وتتداخل فيه فروع مختلفة من العلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية. من هؤلاء القلة من الفلاسفة، الدكتور حسن حماد، أستاذ الفلسفة في جامعة الزقازيق، وعميد كلية الآداب الأسبق بالجامعة ذاتها، فهو يمتلك قدرة هائلة على طرح موضوعات معقدة وشائكة، تجمع بين الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع، بلغة بسيطة وسهلة، ولا يستثنى من ذلك كتابه الذي صدر مؤخراً عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، بعنوان "القمع والمقدس"، والذي جرت مناقشته في ندوة عقدت مساء الأحد في قاعة الدكتور محمود العلايلي بصالون علمانيون، شارك فيها الدكتور أحمد زايد، أستاذ الاجتماع بكلية الآداب القاهرة، ومدير مكتبة الإسكندرية، بحضور نخبة من أساتذة الفلسفة والاجتماع والمثقفين المهتمين.
ونظراً لأن القمع، في جوهره، سلوك عنيف، سواء كان هذا القمع مادياً أم معنوياً، فإن موضوع الكتاب متداخل مع أدبيات أخرى تربط بين العنف والمقدس، لكن المؤلف استطاع أن يضبط الموضوع الذي يتناوله ضبطاً محكماً خلال فصول الكتاب السبعة، وهي مهمة ليست باليسيرة، نظراً لإدراكه أن القمع هو "شكل من أشكال العنف الذي يمارس باسم المقدس"، يستند إلى "الإيمان الواثق بامتلاك الحقيقة المطلقة"، وإدراكه أن هذا القمع المقدس "قمع شامل" لا يقتصر على حرية الإنسانية الدينية أو العقائدية، وإنما يشمل الباطن والظاهر ويستهدف إحالة ما هو دنيوي إلى ديني وإخضاع كل تفاصيل الحياة الإنسانية إلى الرقابة الدينية، فالكتاب يدرس ما أطلق عليه "الشمولية القمعية" التي لا تستثني شيئاً من هيمنه سلطتها، حتى ولو كان شيئاً تافهاً أو هامشياً.
والكتاب صدر في توقيت مناسب للغاية مع زحف خطابات الإسلام السياسي إلى المجال العام من جديد مدفوعة بإحساس بالانتصار الزائف الذي حققه تحالف هيئة تحرير الشام في سوريا، فالكتاب يستفيض في شرح العلاقة الخفية بين القمع وبين استدعاء المقدس في كل شأن من شؤون الدنيا، بزعم أن الدين ينظمها وأنهم قيَّمون على هذا الدين الناظم للحياة في كل تفاصيلها، ويسعى الكتاب إلى تحليل، بل تفكيك الآليات التي يستخدمها خطاب الإسلام السياسي لفرض سيطرته وسلطانه على واقع سياسي بائس ومنحط، وعلى شعوب اعتادت القهر واستمرأت الخضوع وأدمنت صنع الآباء بكافة أطيافهم السياسية والتراثية واللاهوتية، ولم تزل تبحث لنفسها عن مخلص ينقذها من أزماتها المتفاقمة.
التراثيون وجوهر الإيمان
المشكلة ليست في الدين في جوهره أو في الإيمان في حد ذاته، وإنما في تشويه هذا الجوهر وتقييد الإيمان بالتراث الديني والفقهي الذي جرى تجميده وتقديسه بنصوص باتت هي المتون التي يتم استدعائها لممارسة القمع المستند إلى السلطة المطلقة على الناس وقهرهم باسم الدين، بل وتصفيتهم جسدياً إذا ما استشعر القَيِّمون على هذا التراث خطراً يهدد سلطانهم ويتحدى احتكارهم للحقيقة المطلقة. ففي تقديمه للكتاب من منظور اجتماعي، وأشار الدكتور أحمد زايد، في تقديمه للكتاب، إلى أن الأصل في الدين وفي الإيمان هو بعث الطمأنينة في نفوس البشر، وأن هذا الأصل أو الغاية من الدين مشتركة بين جميع الديانات والعقائد على اختلافها، غير أن واقع الحال الذي نراه كل يوم يثبت إلى أي مدى ابتعد الناس عن هذا الأصل أو الجوهر فتحولت الأديان إلى سبب لصراعات دامية وحروب أبدية حول مطلقات تعزل الإنسان عن الواقع المادي الذي يعيش فيه.
وكآلية من آليات القمع المعنوي أو الرمزي، يفرط التراثيون في استخدام سلاح التكفير لكل رأي مخالف لرأيهم ولكل فكر يسعى إلى تحرير الناس من سطوة كلماتهم التي تدعم الاستبداد السياسي. اللافت أن الدكتور حسن حماد بحث الفكرة في الديانات والعقائد المختلفة وانطلق من بحث معنى المقدس ودلالات هذا المعنى في الديانات المختلفة في مدخل مهد لفصول الكتاب التي تناولت بنية السلطة المقدسة وأبوية النص التي تعد ركيزة للقمع الابستمولوجي (المعرفي)، وينتقل لتحليل القوة السحرية للخطاب الديني، ويقدم تفسيرا مهماً لقمع المرأة جسدياً في هذا التراث المقدس، ويستعين بمعرفته القوية بعلم النفس ومدارسه المختلفة لتحليل فكرة الألم وتعذيب البدن في ارتباطها بالمقدس، وما يصفه بميول سادية (نزعة السيطرة) ومازوخية (استعذاب الألم والميل للخضوع والإذعان) في الممارسات اللاهوتية، ليختتم فصول الكتاب بفصل يتناول فكرة جوهرية هي فكرة الراعي والرعية، أو ما يطلق عليه الأب السياسي.
واستعانة المؤلف بعلم النفس محورية وتتجلى في ثنايا صفحات الكتاب الذي سلك سلوكاً مغايراً في دراسته للقمع ليس "كسلطة خارجية تملي أوامرها على الإنسان"، وإنما ارتاد بعض المناطق المظلمة والمعتمة والسرية، التي من خلالها يفقد الإنسان ذاته وحريته وإرادته "وهو راض مبتسم"، فمفهوم القمع الذي يطرحه في الكتاب يتجاوز معناه البسيط الذي يجسد علاقة الخضوع التقليدية بين السيد والعبد، وإنما هي علاقة جدلية تتسم بالحركية ويشير إلى القمع كعملية لاشعورية تتجاوز وعي الإنسان بخضوعه له وتحوله، أي القمع، إلى "سلطة مستبطنة وداخلية تعيد إنتاج ذاتها، وقد تكون أكثر عنفاً وإرهاباً وجبروتاً، من السلطة الخارجية المباشرة. والقمع المقدس، في وجهة نظر المؤلف، هو قهر مزدوج يمارسه الإنسان على نفسه وعلى الآخرين، يبلغ مداه وذروة عنفه عند ممارسته على المخالفين في الرأي وفي العقيدة، ومن هنا يكتسب القمع المقدس شموليته، بعد أن تصبح السلطة الخارجية سلطة مستبطنة تعمل من داخل الفرد كسلطة ضمير أو زاجر أخلاقي، أكثر عنفاً وقهراً من السلطة الخارجية المباشرة، فمع هذه العملية يصبح الفرد جزءاً من السلطة الخارجية خاضعا لها ومستجيباً لأوامرها، بل يصبح مدافعاً ومقاتلا مستعداً للموت من أجل طاعتها وتقديسها.
إن فكرة الحقيقة المطلقة وامتلاكها، هي فكرة جوهرية في إضفاء القدسية على التراث الفقهي والديني، لا لشيء إلا للاعتقاد بأن هذا التراث هو المعبر عن "صحيح الدين"، ورفض أي اجتهادات أخرى لإعادة النظر في هذا التراث ونقده، واللجوء إلى قمع هذه الاجتهادات الأخرى، وغالباً ما تلجأ المحاولات الأخرى لإنتاج فكر مضاد يستند إلى الاعتقاد الخاطئ بامتلاك الحقيقة، وعدم الميل إلى إعمال منهج الشك والتحليل العقلي، إلى الإرهاب الذي هو شكل من أشكال القمع المضاد. ومن شأن مصادرة حرية الرأي والتعبير وحرية البحث وما يتصل به من حريات أكاديمية إلى سقوط المجتمع في هذه الحلقة المفرغة من القمع ومشروعات القمع المضاد على النحو الذي رأيناه في تجارب الحكم التي ارتبطت بمشروع الإسلام السياسي، في باكستان وأفغانستان وإيران وفي المناطق التي تخضع لسلطة تنظيم الدولة الإسلامية، التي لا تعدو أن تكون سوى وجه آخر للاستبداد، بل لأخطر أنواع الاستبداد وهو الاستبداد الديني.
إن هذا الطرح من شأنه يضع أن كتاب "القمع المقدس"، ضمن ما يمكن أن يطلق عليه "أدبيات التحرر" التنويرية التي تسعى إلى تحرير الإنسان من الاستبداد باسم احتكار الحقيقة وباسم الدين، وتسعى إلى تحرره داخلياً من خلال تسليحه بالمعرفة وبآليات التفكير التي تساعده على التفكير النقدي والجرأة في استخدام العقل، واستخدام العقل هنا يعني أمرين: الأول القدرة على التمييز والتصنيف، والثاني القدرة على اكتشاف العلاقات ومعرفة حدود الأشياء والظواهر. ويميز المؤلف في مقدمة الكتاب بين القمع بمفهومه الحداثي الذي طوره فلاسفة غربيون معاصرون مثل ميشيل فوكو وهربرت ماركيوز، ومن قبلهما أنطونيو جرامشي، ومن بعدهما يورجن هابرماس وغيرهم من فلاسفة ودارسين اهتموا بدراسة القمع كفكرة وكظاهرة اجتماعية. ويشير إلى أن الفارق الأساسي بين القمع الحداثي، وبين القمع المقدس، أن الأول يمارس باسم العقل وتوظف فيه تقنيات العلوم الإنسانية ومؤسسات الضبط والمراقبة وشبكات التواصل الاجتماعي، في يعتمد القمع المقدس على سلطة الدين ويقوم على قاعدة أساسها نفي العقل وتكفير كل ما هو حداثي أو إبداعي وإنكار العلم، وفرض حجاب على الجسد والتفكير والحقيقة والمجتمع، وسحق أي محاولة للشروع، مجرد الشروع في الاختلاف أو التفرد أو الحرية ورفض التعددية باعتبارها مصدر من مصادر التشرذم والتفتت.
وتكمن أهمية الكتاب في كونه محاولة لإزاحة الستار عن الآليات الخفية التي يستخدمها رجال الدين للسيطرة على الإنسان وتحويله رأس في قطيع وجعله مهيئً ومستعداً لقبول الطغيان والرضا بالخضوع والعبودية والإذعان، فالكتاب كما يشير مؤلفه في المقدمة "محاولة مستميتة لإيقاظ وعي الإنسان العربي وتحريضه على التمرد على أي محاولة تسعى إلى تغييب وعيه، وينهي المقدمة بتأكيد أن الحرية لا تعني فقط مقاومة القيود وإنما تعني الوعي بهذه القيود. الكتاب ثري بالأفكار التي تستحق كل فكرة منها نقاشاً مطولاً.
----------------------------
بقلم: أشرف راضي